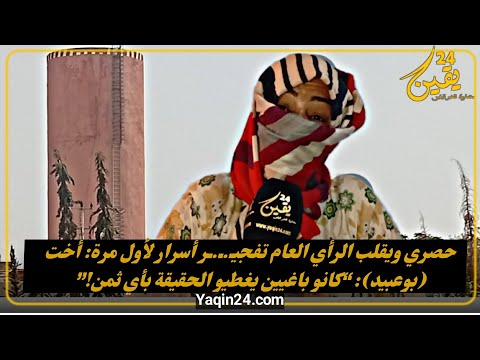يتحدث الكتاب عن القوة، وكيفية الفهم المشترك للقوة التي قد تؤدي إلى كارثة، ثرى، كيف ينتصر الضعفاء في الحروب؟ وعلى ماذا تعتمد إحتمالية النصر والهزيمة في النزالات... على التفاعل بين الإستراتيجيات المستخدمة عند كل من الطرفين القوي والضعيف
كما أن مصطلح "النزاعات غير المتكافئة"
يقصد به في هذا السياق حصر الموضوع الواسع للتساؤلات المتعددة حوله ومع
هذا، فهذا المصطلح يبقى يعاني من نفحة التكبر الأكاديمي وإنفصاله في البرج
العاجي.
وفي الحقيقة، فإن موضوع الحقيقي المتناول هنا هو الوحشية
السافرة في الحروب، حيث أن المتلقي الأولي لهذه الوحشية في العادة يكون
الجنود، فهم مدربون لمواجهتها، وإن بحدود معينة. ومن المتوقع أنهم قد
يصابوا أو يقتلوا من قبل جنود آخرين مثلهم خلال أداء واجبهم، ولكن في
أيامنا هذه، فقد اصبحت الحروب أقل حصرا بالجنود (لكن البعض قد يقول على أن
ذلك مجرد أسطورة أكثر من أي وقت مضى) وربما هي تبعات غير مقصودة لمحاولة
إستخدام إتفاقيات "جنيف".
(ولوسائل اللاحقة للقانون الدولي الإنساني)
لحماية الأطفال والمصابين والمرضى والمرضى العقليين والمعاقين والأطفال
الصغار، والنساء اللواتي لا يوجد لديهن تحمل للأسلحة، وكبار السن، ذلك
الكون هؤلاء مجرد بشر ضعفاء وليسوا جنودا، ولكنهم أصبحوا ضحايا بشكل متزايد
للهجوم بالسكاكين، وبالبنادق، واللهب، والمعدن الطائر، وكلهم كانوا عبارة
عن أهداف لأنافالمقاتلين اليائسين يجدون أنه من المفيد الإختباء بينهم،
والتغلغل في أماكن إقامتهم، بينما كان أعدائهم يفتقرون إما إلى الإرادة أو
القدرة على ضربهم من دون رأي واضح، وبذلك يكون الأطفال الصغار أول الضحايا
التي تتكور جانبا.
عادةً ما يؤدي استخدام القوة المفرطة من قبل الطرف الأقوى في الحرب إلى كارثة إنسانية ودمار يعم البلاد، فيما يكون الطرف المُهاجَم هو الطرف الأضعف الذي لا يملك القدرات الكافية لردع هذا الهجوم. ومع ذلك فإننا نرى في حالات كثيرة أن الطرف الأقوى لم ينتصر بل أن المنتصر هو الطرف الأضعف الذي يؤمن بوطنه وحقه ودفاعه عن نفسه فيتفوق في الحرب أو على أقل تقدير يُفشل أهداف المعتدي ويمنعه من السيطرة على مقدراته.
إذاً، إن النزاعات غير المتكافئة، والتي يكون فيها طرف واحد مالك لقوة هائلة ومع احترام لخصمه، فإن هذه الخصوصية تكون صحيحة. وهي كذلك لأن الضعيف يائس، ولأن القوي لا يستطيع احتمال إساءة المقاومة، فالمقاومة للقوة الهائلة تقدم دليلاً على الشر أو الجنون. ولكن كلاً من الشرير أو المجنون يحتاجان إلى أن تتم معاملتهما كبشر أيضاً. هذا ما يشير اليه إيفان أريغوين توفت أستاذ العلوم السياسية الأميركي في كتابه "كيف يكسب الضعفاء الحروب: نظرية عن النزاعات غير المتكافئة".
يحاول الكاتب التوصل إلى معرفة الأسباب التي تجعل الضعيف ينتصر في الحرب، وذلك لأن انتصار الضعيف على القوي أمر محيّر يقول الكاتب "لأننا نتوقع للأطراف القوية أن تهزم الضعيفة فيما يتعلق بالحروب، والاشتباك بالأيدي، وحتى في منافسات الأعمال والمسابقات الرياضية، فإن حقيقة أن الضعيف يفوز أحياناً هي أمر محيّر".
فالعلاقات الدولية تحتمل عادةً كل النتائج، والكاتب يستند في ذلك إلى النظرية الواقعية في هذه العلاقات، وبذلك يكون بالإمكان أن يفوز الطرفان القوي أو الضعيف على عكس ما تقول نظريات أخرى مثلاً، كنظرية القوة.
تحدث الكاتب عن القوة النسبية والنظرية الواقعية للعلاقات الدولية في الفصل الأول من كتابه، ويقول: "بالعودة إلى وصف القائد العسكري والخبير الاستراتيجي تيوسايدس للحرب بين اثينا وإسبرطة، فإن الصلة بين القوة وبين نتائج الصراع قد أصبحت المبدأ الجذري الأصلي لنظرية العلاقات الدولية الواقعية". وقد استخدم مفهوماً خاصاً لهذه النظرية غير ذلك المعروف، والذي يعرّف الواقعية في السياسة الدولية بأنها بمثابة رد فعل على تيار المثالية، وبما تحمله من أبعاد متشابكة وما تعكسه من مصالح متناقضة وما تراعيه من موازين قوى.
في رأي "توفت" فإن "القوة الأكثر تعني حروباً رابحة، وقوة أقل تعني الهزيمة فيها، لكنه مع ذلك حيث يستند الى النظريقة الواقعية يقول بإمكانية انتصار الضعيف". وهذا وإن كان صحيحاً ومؤكداً، إلا انه أوقعه في التناقض فكان باستطاعته الاستناد الى غير تلك النظرية في العلاقات الدولية، لكن لعل تعريجه على هذه النظرية كان مناسباً لأنه من خلال تأكيده بامكانية بانتصار الضعيف استطاع أن ينقضها.
ويفوز الضعيف عادةً بمقاومته، لأنه يعلم وفق ما يقول الكاتب إن "الهزيمة في الحرب تعني الموت أو العبودية". لكن هذا ليس الشيء نفسه كما يخال لعلماء العلاقات الدولية أو للنخب العسكرية والسياسية لجهة أن القوة المادية هي الفيصل، حيث أن العديد من الأشياء بحسب ما يشير اليه " توفت" بدءاً من العزيمة، التقنية، الاستراتيجية، الحظ، القيادة، وحتى البطولة أو الجبن، يمكن أن تؤدي إلى نتائج غير متوقعة. وهو يقول إن كان صحيحاً فإن القوة هي الأهم، إذا في جميع النزاعات ستكون غير متكافئة، حيث يجب على القوي أن يكسب دائماً، لكن ليس هذا هو الحال دائماً.
منذ عام 1816 كان يقال بأن الأطراف القوية قد كسبت أكثر من ضعفي ما كسبته الأطراف الضعيفة. ولكن من الناحية الأخرى، وحيث أنه في هذا التحليل تتفوق الأطراف القوية على الأطراف الضعيفة بهامش كبير، فإنه يبقى محيّراً كيف خسرت الأطراف القوية في حروب عديدة.
ويشير توفت إلى أن الأطراف القوية كانت منذ 1800 وحتى 1849 قد انتصرت بنسبة 88.2% من جميع النزاعات غير المتكافئة. ولكن هذه النسبة وصلت إلى 97.5% خلال فترة الخمسين سنة التالية ولكن بدءاً من القرن التاسع عشر، فإن عدد النزاعات غير المتكافئة التي انتصرت فيها الأطراف القوية بدأت بالهبوط بشكل واضح حيث انخفضت إلى 65.1% خلال عام 1949. وخلال الخمسين سنة الأخيرة منذ عام 1950 وحتى عام 1999 حيث كانت الأطراف القوية قد انتصرت فقط بنسبة 48.8% من جميع النزاعات غير المتكافئة.
وفق ذلك، فإن النظرية الواقعية للعلاقات الدولية تقودنا من ناحية أخرى إلى أن نتوقع أنه في أي نزاع ذي طرفين، كلما زادت نسبة القوة لصالح أحد الطرفين كلما كان انتصاره أسرع وأكثر حسماً. ولكن من ناحية أخرى، فإن القوى القوية قد خسرت ما يقارب نسبة 30% من جميع النزاعات. وعلى الرغم من أن الكاتب يتبنى هذه النظرية، الا انه يؤكد أنها عرضة لعدم الصحة لأن الشعوب الضعيفة عادة ما تنتصر بإيمانها بوطنها وكرامتها وهذا ما يتوصل إليه الباحث توفت في فصول كتابه.
لقد توصل الكاتب إلى أن القوى الدكتاتورية عادةً ما تنتصر على عكس تلك الديمقراطية، فبعد الحرب العالمية الأولى وخصوصا الحرب العالمية الثانية، هبط عدد الأطراف القوية المستبدة. وبعد عام 1991 انهار الاتحاد السوفياتي ولم يعد طرفاً استبدادياً في السياسات الداخلية. إذاً كانت الأطراف الاستبدادية تحارب في النزاعات غير المتكافئة بشكل أفضل من الأطراف القوية الديمقراطية.
إن الثنائية القطبية في مرحلة الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة قد تدخلت في أغلب الأحيان لكي تواجه القوة الملموسة للقوات المتفوقة الأخرى. إن القوى الديكتاتورية عادةً ما تحسم ميزان القوى أكثر من تلك الديمقراطية في الحرب. وهذا الكتاب يشرح كل الشروط التي سوف تحقق النصر لأميركا في مثل هذه المعارك ولماذا سوف تخسر بكشل أكثر هذا القتال لبناء الديمقراطية فيي أفغانستان والعراق.
ويشير الكاتب إلى أنه بشكل عام، فإن الجهة الفاعلة بأكبر قدر من هذه الثروات من المتوقع أن تفوز وتكسب الحصص لصالح قوتها. ومع ذلك، فإن الفاعلين الأقوياء والضعفاء يستخدمون استراتيجيات تمثل المنهج الاستراتيجي المعاكس: مباشر ضد غير مباشر أو غير مباشر ضد مباشر. ومن المرجح أن يفوز الفاعلون الضعفاء على عكس ما تسمح به الحكمة التقليدية هذه، وهي نظرية التفاعل الاستراتيجي.
ومع أن المصالح هي عامل استراتيجي هام للدولة، لكنه قد يعارضها الشعب في أية حرب تشنها، ومع أنها تعتبر تفويضاً لاحتمال التضامن الوطني. كما في أي اتفاق واسع ضمن مجتمع معيّن وبين النخبة والناس. ولكن من جهة ثانية مثلاً، فقد عارض الأميركيون معظم الحروب التي شنها الجيش الأميركي ومنذ عام 1945.
فضلاً عن ذلك، فإن اللاعب ذا المصالح الكبيرة في المعركة، سيصاب في الشعور بالإحباط في أرض المعركة، في حين أن اللاعب ذا المصالح الضئيلة لن يهزم. فاللاعب كلما كانت مصالحه قليلة كان قادراً على الفوز أكثر، لكن في الوقت نفسه سيتعرض لاحتمال الهجوم أكثر، فقوة وسمعة القوي تحتم عليه تحقيق الأهداف وإلا سيفشل ويحبط، فيما الطرف الضعيف سيكسب فيما لو أفشل هذه الأهداف مع كل ما يتعرض له من كوارث.
لذلك، فإن مدة الحرب تصبح مقياساً لشرعيتها، وخصوصاً الحرب اللامتناسبة التي يكون فيها نصر اللاعب القوي متوقعاً وبسرعة، يقع الكاتب في التناقض لأن وفق كتابه فإن الفوز ليس بالضرورة أن يكون حليف القوي.
ويعرف الكاتب الإستراتيجية بأنه خطط اللاعب لاسعتمال القوات المسلحة من أجل تحقيق أهداف عسكرية وسياسية. وهكذا فإن الاستراتيجيات تميّز مفاهيم اللاعب النقدية عن القيم النسبية لتلك الأهداف. ولذلك فإن الاستراتيجية بهذا المعنى يجب تمييزها عن مصطلحين مترابطين جداً هما (الاستراتيجية العظمى، والتكتيك). حيث تشير الاستراتيجية العظمى إلى إجمالية موارد اللاعب الموجهة نحو أهداف عسكرية وسياسية واقتصادية وسواها. في حين أن التكتيك يشير إلى فن خوض المعارك واستعمال أسلحة متنوعة للقوات المسلحة.
يمكن للاعبين الضعفاء أن يفوزوا في الصراعات اللامتناسبة بسبب الدعم الخارجي أكثر من من مجرد استخدامهم للإستراتيجية المعاكسة المفضلة.
يخلص الكتاب إلى أن الغالبية العظمى من الحروب لا تأتي ضمن نطاق الثقل ولكن يتم تمييزها من خلال الفترة والمرارة وليس الأسلحة، بحيث تكون أكثر قابلية للتدخل الغربي عندما تتطور إلى اشتباكات واضحة بين القوى النظامية. في حين أن الحروب الأهلية تتضمن مقاتلين غير نظاميين ومناوشات في الطرق، وانتشار الارتباك السياسي والاستخبارات. لذلك فإن النصر الحاسم يندر هنا.
وتأتي الأطراف القوية للقتال وفق مجموعات معقدة لمصالحها، وللقوى والمذاهب وتقنية الجيوش والأهداف السياسية، على اعتقاد أن القوات المسلحة ستكون متعددة الأستعمال، ولكن ليس بشكل مطلق. فالأطراف القوية كانت على الدوام تمتلك خياراتها بالاستراتيجيات المستعملة، وبنفس الطريقة، فإن الأطراف الضعيفة تواجه دائماً قيوداً في خياراتها الاستراتيجية، ولكن الاستراتيجية بصدد التطور والتبدل الدائم.
إسم الكتاب: كيف يكسب الضعفاء الحروب - نظرية عن النزاعات غير المتكافئة
اسم المؤلف: إيفان أريغوين - توفت
اسم المترجم: أدهم مطر
عدد الصفحات: 330 صفحة
الطبعة الأولى 2013م